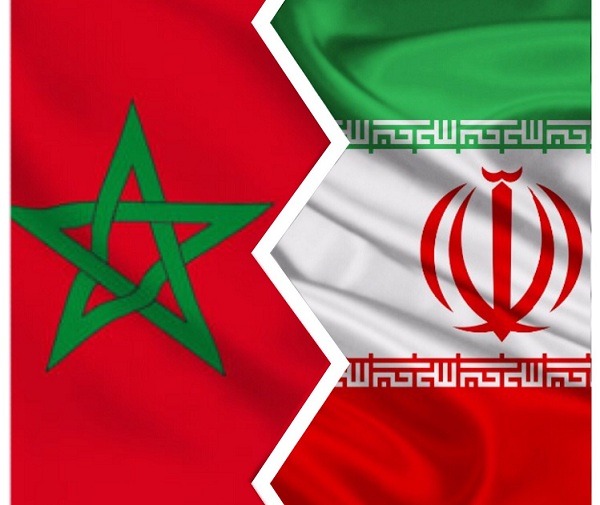في تقدير باحثين مؤرخين مغاربة منسية هي علاقات المغرب مع بلاد المشرق، لدرجة من سَلفِ هؤلاء من نبه لِما كاد أن يصيبها من خجل ويعصف بها من اضمحلال، مقابل ما أحيطت به العلاقات المغربية الأوربية من إقبال وعناية بل ومن تنافس لبناء صروح لها من الدعاية، علماً أن العلاقات المغربية المشرقية مثناً وسياقاً تتميز عن مثيلاتها بتجاوزها ما هو سياسي من خلال حضور ما هو مجالي بشري ثقافي لغوي وروحي.
وكان حقل تاريخ العلاقات المغربية الأجنبية عموماً قد استقطب عدداً من الباحثين المغاربة منذ فترة، وعليه ما حصل من اهتمام بهذا المجال ومن ثمة تراكم نصوصٍ على قدر عالٍ من الأهمية لفائدة خزانة البلاد العلمية. ولعل بقدر ما هناك من دراسات توجهت بعنايتها لِما هو علائق وتفاعل ديبلوماسي يخص زمن المغرب المعاصر، بقدر ما هناك من جوانب كانت بحاجة لتنقيب وبحث وابراز ومقاربة وتحليل ونقاش واثارة وتنوير وتوثيق، دعماً وخدمة لقضايا بلاد استراتيجية من جهة وترتيباً لخيارات حاضرها ومستقبلها معاً.
العلامة ابن حزم الأندلسي.. حين اعترف بإخفاق حُبّه مرتين! - أحمد إبراهيم
"إني كُنتُ أشدّ الناس كلفا وأعظمهم حُبا بجارية لي كانت فيما خلا اسمها نَعم، وكانت أُمنية المتمني، وغَاية الحُسن خُلقا وخَلقا وموافقة لي، وكنا قد تكافأنا المودّة، ففجَعتني بها الأقدار، واخترمتها الليالي ومر النهار، وصارت ثالثة التراب والأحجار، وسِنّي حين وفاتها دُون العشرين سنة، وكانت هي دوني في السن، فلقد أقمتُ بعدها سبعة أشهر لا أتجردُ عن ثيابي، ولا تفتُر لي دَمعة على جُمود عيني". (ابن حزم عن حبيبته نعم)
أنجبت الأندلس طوال تاريخ الإسلام فيها الذي استمر لثمانية قرون عباقرة وعظماء في ميادين الشريعة والعلوم والآداب والفنون، فضلا عن السياسة والعسكرية، ودُعاة على درجة كبيرة من العفّة والصيانة.
وفي نهاية عصر الدولة الأموية في الأندلس، وفي سنوات ازدهارها الأخيرة واضطرابها أيضا، وفي بيت من بيوت الشرف والمكانة والسُّؤدد فيها، وُلد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم في عام 384هـ/994م، وهو واحد من الرجال الفطاحل في تاريخ الأندلس وعباقرة ميادينها الفكرية والفلسفية والدينية؛ ذلك الرجل الذي يبدو أنه جمع المتناقضات فصار رأسا للمذهب الظاهري، وفقيها مُتبحِّرا مقارنا في المذاهب الفقيهة كلها، وفيلسوفا متأملا، بل ورجل سياسة، إذ كان والده من الوزراء الكبار، وكان في الوقت ذاته ذا عاطفة جيّاشة، ونفس مُرهفة، وقلب يعرف للحب قدره!
النزوع الإنساني والكوني في الشعر الصوفي: ابن عربي نموذجا - د. علي كرزازي
من أهم خصائص التجربة الصوفية هذا البعد الكوني الذي يسم القيم المعرفية والأخلاقية والتربوية والجمالية التي تنطوي عليها،وفي الآن ذاته، يتساوق أيما تساوق مع جوهر الشريعة وثوابت الدين الإسلامي وكذا مع المبادئ الكونية التي تشكل المقاصد البعيدة للأديان والفلسفات الكبرى ذات العمق الإنساني.
ولن نمتر في حقيقة كون ابن عربي واحد من أولائك الصوفيين الذين نجحوا في جعل التصوف منجما أخلاقيا وروحيا متنوع المكونات ومتعدد المجالات وثر المسارات،و منهلا للقيم والمثل الكونية التي يمكن أن تعتمد كقاعدة لتأسيس بنيات الحوار والتعايش والتآخي و التسامح بين المكونات الداخلية للثقافة الإسلامية من جهة، و بينها و بين الثقافات الأجنبية من جهة أخرى.
ابن باجه فيلسوفٌ ظُلِمَ حياً وميتاً - عبد الصمد البلغيــتي
علاقةُ ابن باجه بزمنهِ كانت متوترة وسيرتهُ تميزت بالكثير من المحنِ، نظراً لكونه أولُ المشتغلين بالفلسفة وعلومها في الأندلس، دافع عن الإنسان وحرية الإرادة والإختيار فيه، واعتبر العقل قيمة مطلقة وفصلَ بين العلم والدين فصلاً واضحاً في نظرياته العلمية، وأكد أن مجال البحث العلمي يقومُ على التجريب والبرهان، ومجال الدين والإلهياتِ يقُوم على الغيب والإيمان، من هنا كان شخصية أندلسية تنويرية مرموقةً وظف قلمهُ للبحث العلمي في مجال الطبيعيات كالحيوان والنبات والفلك وفي مجال المنطق والأخلاق والسياسة...غير أن عصره ظلمه كثيراً وتعرض له العامةُ والخاصةُ وسعوا في قتلهِ والنيل منه، ولم يسلم حتى بعد موته إذ لم تنل كتبه وفلسفته عنايةً ولم تجد إهتماماً من الدارسين والمفكرين وطالهُ النسيان، لهذا يستحق بالفعل لقب الفيلسوفُ الذي ظُلم حياً وميتاً.
الحضارة والسلطة في السوسيولوجيا الخلدونية - عزالدين عناية
وفق التقليد الغربي، شهدَ النصف الأول من القرن التاسع عشر ميلادَ تخصّص علم الاجتماع. وهي فترة عرفت تحوّلات تاريخية عميقة أيضا، وصادفَ أن رافقتها صياغة الأُطر النظرية لأوغست كونت الذي يُنسَب إليه نشأة هذا العلم في الغرب. بَيْدَ أنّ عبد الرحمن ابن خلدون، ومنذ العام 1377م، قد صاغ مؤلَّفا متفرّدًا بعنوان "المقدّمة"، حدّد فيه أصول علم جديد، لم يسبق التطرّق إليه من قبل. هَدَف فيه إلى التحليل العلميّ والصارم للماضي، وإلى بناء إطارٍ يستوعب الحاضرَ ويستشرف المستقبلَ. نشير أنّ "كتاب المقدّمة" قد جرت ترجمته إلى اللسان الفرنسي إبّان الفترة التي شهدت وَلعًا بهذا العلم في الأوساط الغربية. كما يبقى المفكر الإنجليزي أرنولد توينبي من أوائل الغربيين الذين أشادوا بريادة ابن خلدون في صياغة فلسفة للتاريخ الاجتماعي لم يسبقه فيها أحد في أي مكان وفي أي زمان.
نـحـن والـتـراث - محمد نيات
علاقة المسلمين بتراثهم الديني شديدة الغرابة والتعقيد، فهم ملزمون بتصديق وتقديس كل ما جاء فيه من " حقائق " لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ومنهيون في الوقت نفسه عن الخوض في كل ما من شأنه أن يزعزع الإيمان بالثوابت التي أرستها المنظومة الدينية، حتى وإن خالفت الواقع والعلم ووقائع التاريخ، والحس والذوق الإنسانيين السليمين....
ولا بد من الإشارة هاهنا، أنه وحينما نتحدث عن تراثنا الديني الإسلامي، فإننا نعني به ـ وإذا ما استثنينا النص القرآني الخالص ـ أنه هو ذلك المجهود الفكري الذي أنتجه رجال الدين المسلمون على مر العصور الماضية، بل أنه وحتى النص القرآني نفسه لم يسلم من اللمسة البشرية، إبان عمليات الكتابة والتصحيف والتدوين والتنقيط والتشكيل والتهميز... وهو ما يفسر وجود قراءات متعددة للقرآن، واختلاف بعضها عن بعض في العديد من الكلمات والمقاطع.
موقف ابن رشد الأندلسي من صورة الجنة والنار في الخطاب الديني - عبد الصمد البلغيـــتي
لم يكُن لمحنةِ ابن رشد الأندلسي عنوانٌ واحدٌ، فهُو الفقيه والطبيب والفيلسوف والوزير الذي اجتمع الفقهاءُ في مسجد قرطبة ذات يومٍ لتكفيرهِ والنيلِ منهُ، تعددت أسبابُ الفتوى لكن القصد واحدٌ، هو منعُ شخصيةٍ متنورةٍ من التفكير ومحاكمةُ الرأي والاجتهاد، لقد كان ابن رشد ضحيةً لمواقفه السياسية في عهد دولة الموحدين واجتهاداته الفقهية التي لم تكن تروقُ لفريقٍ من فُقهَاءِ الجمُودِ والتقليدِ، ولم تكن صُكُوكُ الاتهام بعيدةٌ عن رقابةِ هؤلاء، أغلبها موجودٌ في كتبه كرأيٍ واجتهادٍ من أجل مُقارعةِ الفكرةِ بالفكرةِ وردُهَا أو قبولها، لكن عقليةَ الجُمُودِ والاستبداد تُفضِلُ محاسبة الضمير والتفكير وممارسة الوصايةِ، وتوزيع تهم التكْفِيرِ وما يتبعها من أشكال العنف والترهيب، ومن بين الآراءِ التي شكلت عنوانا لمحنة ابن رشد موقفهُ من الجنة والنار، وما سمي بمشكلة الحشر والمعاد الأخروي.
دانتي والإسلام - عزالدين عناية
تلوح علاقة متينة بين العمل الإبداعي للشّاعر الإيطالي دانتي أليغييري (1265-1321م) في "الكوميديا الإلهية" والتراث الإسلامي لا تخفى عن عين الدارس الموضوعي، ولا سيما في التشرّب لفلسفة التصوّر الإسلامي من حيث بناء الكوسمولوجيا الدانتية. فلا شكّ أنّ ثمّة هاجسًا في الفلسفة الغربية بمحاولة "التّناسي" للبُعد الإسلامي من الجذور التكوينية للفكر الغربي الحديث، كما يسمّيه المفكر الإيطالي المعاصر ماسيمو كامبانيني. وهو نكرانٌ لطالما مُورس وحاولت العديد من الأطراف الدينية والسياسية ترسيخه، منذ انطلاق الحملات الصليبية وتأثيرها القوي في انبناء جدار نفسي بين الحضارتين. عمل العديد من الكتّاب على تعميق هوّة الفصل بين كلّ ما يمتّ للحضارة العربية الإسلامية بما له صلة بالحضارة الغربية. ويبرز التمايز جليّا بين الشرق والغرب مع ذلك الموقف الجائر لِفرانشيسكو بيتراركا في قولته الشهيرة: "أمقت ذلك النّسب إلى العرب" في "الرسالة الثانية إلى دوندي" التي ظهرت خلال القرن السادس عشر في كِتاب الرسائل "سينيلي"، وهو محاولةٌ للتملّص من الروابط التاريخية بين الحضارتين، أكان ذلك مع التجربة الأندلسية أو مع التجربة الصقلّية.