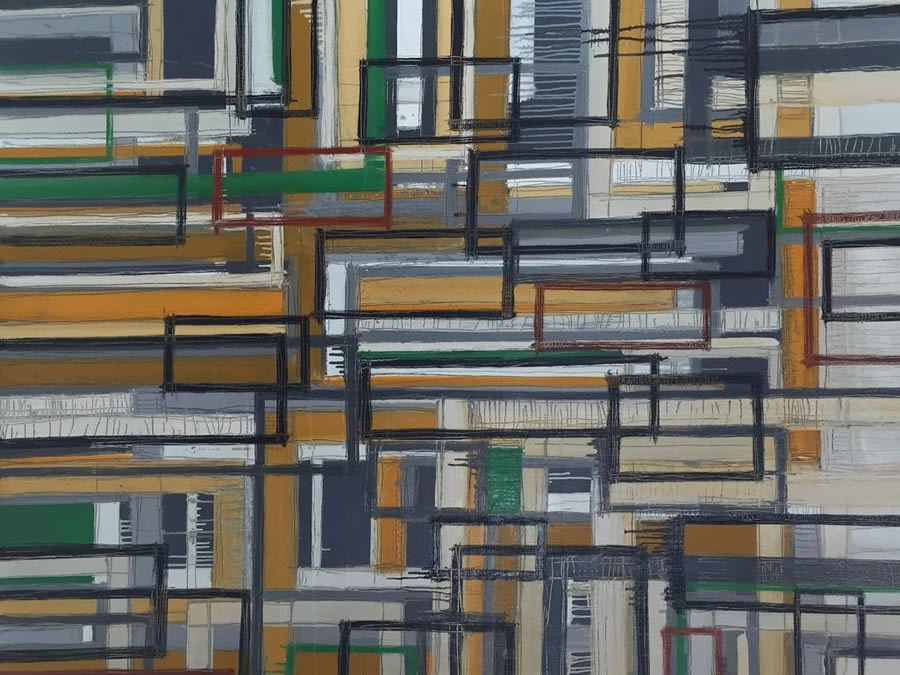( يغلب عليها حرف القاف لقوته وقلقلته بين الحروف )
قال "قاسم" لصديقه "قدور" لقد قضَّني الحَنَق في مرقدي ياصديقي من نقض الحقوق والقوانين وسحقها في أقاليم وأقطار العقوق والمروق..
والمتفاقمة من أقصى الشرق وبقاع سمرقند والعراق – أرض الشقاق- والقوقاز إلى أنفاق قمعستان وقيرغيزستان القريبة من القوقاز . حتى إن الطبقات المسحوقة برحيق الاسترقاق والتي تئن من تضييق الأرزاق ، لا قبل لها بثقلها على الأعناق والأحداق والأشداق..
قال "قدور" : ياصديقي المقرب الى قلبي الحق حق ، فلا يقبر أو يقهر.. ولا يستحق أن يستقر في قرار سحيق .. أو يلقى في قعر عميق..
الحقوق والقوانين قميئة أن تتوافق مع الواقع وإلا انقرضت وانسحقت..
فلا تقلق ياصديقي قاسم.
قال "قاسم" أتفق مع مقولتك أن الحقوق قميئة بتوافقها مع الواقع..
مذكرات زوج مفكر في بلاد الفايكنغ – نص: زكية خيرهم
في مغامرات طفولتي المزهرة، كنت أزرع في قلبي بذور التذمر، مراقبًا كيف تتفجر الشرارات لتقزم لعبي وتمسخ أفكاري، كمن يرسم بالفحم على جدران ذاكرتي. كنت كبرعم غير متفتح بعد، يتساءل في جدية كوميدية: "هل أنا من كوكب آخر؟"، غير قادر على تحديد موطني في هذا الكون المترامي الأطراف. أذكر كيف كانت ضحكاتي تنطلق، لا من الفرح، بل من روح تستهزئ بكل شيء، من الأفق اللا متناهي إلى السماوات الشاسعة، متمردًا على النسيم، محتجًا على الدموع الغادرة التي تسرق الفرح من عيني. كانت أفكاري المشتتة - من الأحكام إلى القيم والمبادئ - تبدو كقيود تثقل كاهلي، تخنق براعم الحرية لدي وتكبل أجنحة الإبداع. كثيرًا ما كنت أتساءل، في لحظات فكاهية ذاتية، لماذا أنا، من بين كل الناس، أرى ما لا يرون وأشعر بما لا يحسون؟ هل لأنني مخلوق فضائي، أم لأن هذا الأنف الكبير الذي كان مصدر تسلية أخي قد منحني هذه القدرة الخارقة؟ وبفضل تفكيري العميق، أهداني القدر صلعًا مبكرًا، تاركًا لي خصلات قليلة يتيمة، تحاول بشجاعة أن تضيء ظلمة الليل كنجوم قليلة وخجولة. في أحضان أسلو، تلك المدينة اللطيفة التي لم تكن قط في قائمة أمنياتي السياحية، وجدت نفسي ضائعًا في كوميديا الأخطاء، حيث الثلوج تتنافس على منح أفضل عرض للجمهور والليالي طويلة كمسلسلات الدراما التركية. بدأت هنا مغامرة لم أسجل لها في دورات التدريب، فصل جديد يضع "المغامر" بدلاً من "النبي المزيف" على بطاقة تعريفي. أهلًا بك في النرويج، حيث الأحلام تتخذ شكل فطائر الوافل والحياة ملونة ككرات الديسكو. في أيامي الأولى، كان كل شيء يبدو كأنني انقلبت من كوكب آخر، من السكان الشقر إلى الطبيعة التي يمكن أن تكون بطاقة بريدية. وأنا أتجول في أسلو، تلك المدينة العريقة بمبانيها التي قد تعتبر معالم تاريخية أو مجرد مراكز تسوق قديمة، كنت أحاول استيعاب هذا الكوكب الجديد. من الأضواء التي تزين المدينة كأنها تحتفل بعيد ميلادها كل ليلة، إلى الناس الذين يحملون قصصًا قد تصلح لمسلسل أو فيلم وثائقي عن "سكان الشمال. وأنا، ذلك الغريب الذي يبدو كشخصية من كتاب طبخ عالمي، تعلمت لغتهم، وغصت في ثلوجهم، وحاولت أن أفهم إذا ما كانوا يضعون الكريمة على كل شيء كما يفعلون مع القهوة. وفي أعماقي، كان هناك هذا النقاش الداخلي الطريف: هل أنا هنا للبقاء أم مجرد زائر يتساءل عن مكان البيتزا الجيد؟ في الليل، بينما أتأمل الأضواء الشمالية التي تبدو كحفلة ليزر فاخرة، كنت أجد نفسي محاطًا بالغربة، تلك الغربة التي تجعلك تتساءل: هل كل هؤلاء الناس يشعرون بالبرودة مثلي أم أن لديهم جينات مضادة للثلج؟ في نهاية المطاف، بينما كنت أقارن بين النرويج وبلادي، بدا لي أن الحياة هنا تمزج بين الحفلات والاحتفالات بالنهار القصير والليالي الطويلة التي تعطي فرصة لمشاهدة المزيد من الأفلام. وأدركت أنني، على الرغم من كل شيء، قد وجدت في هذه الأرض مكانًا يمكن أن أسميه منزلاً، حتى لو كان الجيران لا يفهمون مزاحي دائمًا.
نـاديـــن – قصة: أمينة شرادي
صرخت وسقطت أرضا. غابت عن الوعي، اقتربت منها ابنتها نوال، حاولت اسعافها. ارتبكت، بحثت عن هاتفها، اتصلت بوالدها. هاتفه مقفول كالعادة. عندما يغادر البيت الى العمل أو المقهى، يقفل هاتفه ولا يهتم باحتجاج ابنته أو زوجته التي قالت له يوما في عز غضبها " أكيد سأموت بسببك. كيف سنتصل بك إذا كنا بحاجة اليك؟".
اتصلت نوال، بالإسعاف وهي ترتجف وتنام بين الغضب والخوف والحزن. كان لصراخها وخوفها على والدتها "نادين" الأثر القوي على ذلك الصمت الليلي الذي كان يخيم على المكان. سألتها جارتها: "أين والدك؟" احتارت في الإجابة، ونامت دمعة ثائرة بين مآقيها، وقالت محاولة تلميع صورته:" انه مسافر، لقد اتصلت به وسيحضر بعد قليل."
مكثت طوال الليل الى جانب والدتها نادين، تمسك يدها وتحضنها. وفي نفس الآن، تلقي نظرة على هاتفها ربما يحن والدها لصراخها الذي مزق هدوء ذلك الليل الصيفي. ظلت نادين، غائبة عن الوعي، لكن رفضت ابتسامتها التي لازمتها في أحلك أزماتها معه أن ترحل، كأنها حارسها الأبدي من كل مكروه. فتحت عينيها ببطء شديد، نوال ابنتها على جانب السرير وهاتفها بين يديها. مسحت بيدها على رأسها كأنها تقول لها، "أنا ما زلت معك، لا تخافي انني اقوى من غياب والدك."
كان يوما خاصا، لا يشبه باقي الأيام العادية بالنسبة لنادين. يوم التقت بزوجها أحمد. كانت تركض في الشارع وتصرخ بكل قوتها الى جانب باقي المتظاهرين رافضين التضييق على حرية التعبير. نادين، كانت تخطو ببطء في عالم الصحافة، تهتم كثيرا بكل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، وتحلل وتطرح الأسئلة كمن يبحث عن ابرة في قش. كانت ترفض أن يزج بها في الجريدة بخانة الطبخ وتموت كل طموحاتها السياسية والفكرية. الكتابة بالنسبة اليها كالهواء والماء، لا تستطيع أن تتنفس من دونهما. كانت تجري وترفع صوتها، يعلو في الفضاء كسهم محارب يدافع عن أرضه. أثناء المسيرة الاحتجاجية، اقترب منها شاب وسيم ويظهر على ملامحه الجدية والمسئولية. سلم عليها وقال لها" ان حرية التعبير هي عنوان تقدم الشعوب." ابتسمت وتابعت سيرها العنيف الذي يحمل رغبة شديدة في تغيير الوضع المأزوم. كانت تدك الأرض برجليها دكا، كأنها ترغب في اختراقها واخراج ما بباطنها حتى تختلط الأشياء وتولد البلد من جديد. لم تجبه، ظل ماشيا الى جوارها. وقال لها " أنا أيضا كنت من المؤيدين لهذه المسيرة الاحتجاجية."
طل يوم جديد على نادين وهي بالمصحة، نوال ابنتها نائمة الى جانبها على سرير آخر. فتحت عينيها وهي تتأمل أن تجده الى جوارها وتفرح بتلك الابتسامة التي أسرتها يوما. جالت بنظراتها داخل الغرفة، كأنها تبحث عن شيء مفقود منها. رمقت ابنتها، نائمة بشكل غير مريح، من شدة التعب والخوف. فهي لم تفارقها وكانت كالمجنونة تريد أن تفهم ماذا أصابها بتلك السرعة. مسحت الغرفة من جديد بنظراتها المتعبة ثم توقفت عند الباب، ربما سيطل بعد قليل، ويرتمي بين يديها ويقبلها ويطلب منها العفو لأنه كان مشغولا وكان هاتفه مقفلا.
بعد انتهاء المسيرة، كانا قد تبادلا رقمي هاتفيهما، وتواعدا على اللقاء. كثرت لقاءتهما وتعودا على بعض. و لا يمكن أن يمر يوم دون أن يلتقيا. استيقظت نوال مفزوعة على صوت الممرضة التي أتت تبلغ والدتها بأن حالتها قد تحسنت ومرحلة الخطر قد عدت. بكت كثيرا من فرحتها وقبلت أمها التي كانت بالأمس بين الحياة والموت. استسلمت نادين، من جديد الى حنين الأمس وتركت الحرية لنظراتها ترحل وتنتظر قرب باب الغرفة على أمل أن يظهر أحمد. ستغفر له كما عودته على كل هفواته وغياباته. ستغفر له صمته الطويل بالبيت وانزواءه بغرفة الجلوس مع هاتفه. ستغفر له اقفال هاتفه كلما غادر البيت كأنه يرغب في الانسحاب من حياتها والذوبان في عالم آخر. ستغفر له لأنه الحب كله بالنسبة اليها. وكان دائما يقترب منها ويحضنها ويهمس لها بين أنفاسها على انها هي الحب كله. وتبتسم وتبدأ صفحة جديدة كمن يولد لأول مرة ويرى الدنيا بعينين حالمتين باحثتين على الأمل والحياة. سألت نوال بصوت يحمل أثار الألم والحزن: "ألم يتصل والدك؟"
نظرات نوال قلقة لأنها كانت تتمنى أن تسمعها الجواب الذي ترغب فيه. لكنها حاولت ان تختار أحسن الكلام، حتى لا يكون صدمة قوية على روحها كمن سقطت عليه صخرة من أعلى قمة جبلية، وقالت لها "أكيد سيتصل يا ماما، أنت تعلمين أنه يقفل هاتفه كلما خرج من البيت. أكيد أن هاتفه مازال مقفلا."
لكن نادين كانت تدرك في قرارة نفسها بانه بالبيت. وبأنه سعيد هناك لوحده، وبأنه يعد طعامه لوحده، وبأنه يتنقل بين التلفاز وشاشة هاتفه. أو ربما فرح فرحة العمر لما ولج البيت ولم يجد من ستمطره بالأسئلة التي يكرهها ويعتبرها كاستنطاق بوليسي. أو أنه نائم كما تعود دائما، لما يعود في آخر الليل ويدلف داخل غرفته وينام. ظلت حبيسة أسئلتها وتكهناتها طوال اليوم. تحسنت حالتها وأمر لها الطبيب بمغادرة المصحة على أن تهتم بصحتها كثيرا وتبتعد عن كل الضغوطات.
كانت مستلقية على السرير في انتظار ابنتها، سافرت بذاكرتها خارج الغرفة، توالت المسيرات الاحتجاجية السلمية والرغبة في تغيير الحصار المفروض على حرية التعبير التي أصبح كالكمامة على الأفواه. كان هناك الى جانبها، هتافات ولافتات وحماس شعبي ترتعش له الأبدان والعقول. في لحظة جد مفاجئة، حوصروا برجال الأمن وتم القبض عليهما على أساس أنهما يساهمان في الفوضى والشغب. تم الافراج على نادين فيما بعد وظل أحمد محبوسا أسبوعا كاملا. تذكرت كيف كانت تقضي يومها وليلها في انتظار الافراج عنه. شاخت قدميها ودمت أصابعها من كثرة الوقوف والذهاب والإياب. لم تمل ولم تيأس لأنها كانت مؤمنة بقضيتهما وكانت مؤمنة أيضا أنهما يمارسان حقوقهما الدستورية ولم يساهما في أي شغب. بعد أسبوع، كانت هناك، تنتظره، وجدت عددا كبيرا من الناس فيهم الأب والأم والأخت والصديق، كل واحد جاء يحمل بين يديه قلبه في انتظار سماع خبر الافراج الجماعي. تجمهر كبير، حجب عليها الرؤيا، رؤوس تتمايل يمنة ويسرا، تتعالى في الفضاء، أيادي تنادي وأصوات تصرخ. اشتبكت الحناجر والأحاسيس واهتز المكان. كل واحد ينادي على قريب له. حالة من الذعر والفرح والدموع. كانت نادين في آخر الصف، تنتظر وتترقب كمن ينتظر نتيجة الامتحان. طل بقامته الطويلة وشعره المشعث، كانت تحب فيه هذه الفوضى المستوطنة لجسده، كان لا يهتم بتناسق الألوان في لباسه، ولا بتسريحة شعره، كان يعتبر كل هذا ترفا لا فائدة منه. كان يبحث بين الجموع عليها. سرت قشعريرة بين ضلوعها وارتفعت نبضات قلبها وانطلقت كالسهم تخترق الصفوف وتبحث عن منفذ يوصلها اليه. سمع صوتها، التفت، ارتمت بين أحضانه وتمنت ساعتها لو أن الزمن توقف حتى تعيش تلك اللحظة القوية وتختبئ بين ضلوعه. قبلها وقال لها" لم أكن أدرك أنني أحبك كل هذا الحب؟".
دلفت نوال داخل الغرفة، تساعد والدتها على جمع حاجياتها ومغادرة المصحة. سألتها من جديد، وصوتها يحمل كل الأمل " هل اتصل والدك؟" ترددت نوال في الإجابة، حاولت أن تغير دفة النقاش مستغلة وضعها الصحي وما قاله لها الطبيب. لكن صمتها أشعل النار بداخل قلبها المرهف، وأعادت السؤال على نوال. توقفا قليلا خارج باب المصحة، في انتظار سيارة أجرة. حضنت نوال والدتها وقبلتها وقالت لها" أعلم أنك تتألمين لغيابه الدائم وعدم اهتمامه بك أو بنا، لكن يا أمي، والدي حنون جدا وطيب جدا غير أنه له طبائع لا تحتمل. أرجوك، لا تهتمي. أنا معك"
كانت نوال تعلم أن الأمر ليس بهذه السهولة، فقد جعلت منها الأيام الماضية، شاهدة على صراع مستمر بين والديها وخصوصا غياب والدها المتكرر واقفاله لهاتفه كأنه يتحلل من كل مسئولية. لم تفهم سبب سلوكه حتى نبتت برأسها فكرة التجسس عليه. فهي تخاف من الغد الذي لا لون له، فأصعب شيء على النفس هو عدم معرفة المجهول الآتي. فهي تحب والديها وتخاف على أمها من الانهيار. وتكره كما يكره كل مظلوم أن يعاقب ظلما، أن يفترقا يوما وتعيش بين بيتين وعطلتين وحياتين، فبيت الأسرة هو وطنها الذي تعلمت فيه أولى خطوات الحياة، ونطق فمها أولى الحروف ولعبت فيه أولى لعبها. فهي ترفض بتاتا أن يهدم أو يبنى في مكانه بيتا آخر. "الوطن لا يموت "كانت تهمس دائما لروحها لما تكون تقتنص بعض لحظات الراحة والمتعة النفسية بعيدا عن كل ضجيج وصداع الرأس. لكن هذه الفكرة لم ترق لها، هل تحادثه في الموضوع حتى تفهم ما يجول بخاطره. ظلت حبيسة حيرة استوطنت عقلها وسلوكها، حتى وهي في المصحة مع والدتها، كانت الأفكار تطاردها كما يطارد المجرم من العدالة.
غوص - قصة: الحسين لحفاوي
القاعة فسيحة ومضاءة بنور باهر متناسق مع الألوان التي طليت بها الجدران التي تفنن التلاميذ المفتونين بالألوان في تزويقها رفقة أستاذ الرسم الذي جمعهم في ناد يمارسون فيه أنشطتهم الإبداعية. تدافع التلاميذ على الدخول. علا الضجيج وارتفع اللغط كل يبحث عن الرقم الملصق على الركن الأيمن من المقعد. حِيزَت الأماكن وتناثروا فوق المقاعد وأطبق على القاعة صمت، تطلعت العيون إلى الظرف المختوم بين يدي الأستاذ. كان كل التلاميذ في لهفة لمصافحة ورقة الامتحان. بعض العيون اخترقت الظرف وتسللت إلى الكلمات تتهجاها تسترق النظر علها تلتقط بعض الحروف. شردت الأذهان وبحلقت العيون. وفجأة دق الجرس معلنا بدء الحصة، فازداد نبض القلوب وارتفع صوت وجيبها وخيم الصمت على القاعة فلم يعد الأستاذ يسمع غير الأنفاس تعلو وتنخفض. صوت نزع اللاصق من على الظرف بدا كمثل هبة ريح قوية ارتجت له الأجساد وتردد صداه في أرجاء القاعة.
سُحبت الأوراق من داخل الظرف في حركة عمد الأستاذ إلى جعلها تثير مزيدا من التطلع في نفوس أعياها الانتظار. وبدأ توزيع الاختبارات على التلاميذ. ما إن وُضِعَت الورقة الأولى فوق طاولة التلميذ الذي قُدِّر له أن يكون مجاورا لمكتب الأستاذ المراقب، حتى بدأت الوشوشات، وتحول الهمس إلى كلام مسموع. سرت كلمات مشفرة بين الممتحنين. تحركت الشفاه فالتقطت الآذان المرهفة تلك المبهمات وفكت شفرتها: النمذجة، الهوية، الفن.
صمت مطبق يعم القاعة من جديد، لحظات اكتشاف وتجلٍّ وانصبت العيون على الأوراق وانشدت الأذهان للكلمات، وراح التلاميذ يقرؤون الأسئلة، يتأملون ويتألمون. ارتفع صوت من وسط القاعة يشق الصمت الذي كان مخيما "عَوْجُونا"، علت على إثره الهمهمات واختلطت المشاعر بين مستبشر ومتذمر. نقر الأستاذ بأصابعه نقرات خفيفة على المكتب فعاد الهدوء إلى القاعة. بعض الوجوه علاها الوجوم، وطفت الفرحة على أخرى. لكن لا مفر، على الجميع أن يفكر، أن يكتب، أن يحلل، أن ينثر أفكاره ويعرضها، أن يُجري الامتحان.
اعترافات دفتر - الحسين لحفاوي
تبعته يوما. كان يمشى أمامي. شعر بأني أراقبه فلم يلتفت، لم يكن يهتم لوقع خطواتي التي دنت منه. بهيأته المديدة وشعره الأشعث المغبر لمحته يدلف إلى المقهى فتبعته. رأيته يجمع الأكواب ويسكب بقايا القهوة في إحداها ثم يشرع في التقاط أعقاب السجائر وينزوي في ركن معزول من المقهى الضاج دوما بالزبائن ثم يشرع في إشعال تلك الأعقاب الواحدة تلو الأخرى. كثيرة هي أثار كيِّ نار السجائر على معصميه وظهر كفه. لم يتعلم من الحياة دروسها مهما حاول أن يكون مجدّا في التعلم. ظل يراوح مكانه متأرجحا مثل بندول ساعة معلقة على جدار محطة هجرها المسافرون فلا يتوقف فيها القطار. لم يتقدم ولم يتأخر، حسبه أنه يحيا.
الوجه شاحب والعينان غائرتان والوجنتان بارزتان وعظام الكتفين ناتئة. أرسل شعر لحيته القليل وتركه دون تشذيب فتناثر فوق وجهه وقد غلب بياضه سواده. هدته الأيام وتغضّن جبينه. لم أعرفه عندما وقعت عليه عيناي. لم أره منذ زمن. كبر خلاله عقدين كاملين، وَخَطَ لشيب فوديه. تسمرتُ في مكاني أحدق فيه، أتملى ملامحه وقد فعلت فيها الأيام فعلها. لم يكن يراني، كان يقف قبالتي لكن عينيه كانتا تحدقان بعيدا، تتبعان خطى روحه الهائمة التي لا تعرف الاستقرار في مكان. ما يكاد يجلس حتى ينهض من جديد ويسير ينوء تحت كلكل من الهموم الثقال والخيبات المتعاقبة. أعرضت عنه الدنيا، صفعته بلا شفقة، كالت له الضربات الموجعة، أنشبت أنيابها الحادة في لحمه البض الطري حتى بلغت العظام. لم ترحم غربته ولا ضعفه، تجاهلت يتمه وعذابات السنين التي قاساها.
الإحساس بالفقد رهيب ومرعب والأنكى منه فقد الوالدين عندما نكون في أمس الحاجة إليهما. هكذا استقبلته الحياة يتيما فذًّا. لم يحس يوما بدفء حضن أم ولا حماه جناح أب. ضُرِبت عليه المسكنة منذ صرخ الصرخة الأولى وتدحرج زغلولا بلا ريش إلى هذه الدنيا. مدفوعا على الأبواب شبَّ تتقاذفه الليالي والأيام، تسلمه المواجع للمواجع. أضناه البحث عن مأوى آمن يلجأ إليه. محروما من اللجوء إلى حضن أمه فكواه برد البلاطات في المحطات وعلى عتبات المساجد وعلى أرصفة الطرقات. قشة ذرتها الرياح ولَهَتْ بها فتطايرت في الفضاء ورحلت بها من مكان إلى مكان. مضت به الحياة عبر دروب ملتوية ملغومة لا يدري متى ينفجر عليه أحد الألغام فيفتت جسده النحيل. ولج متاهات وعرة وخاض عباب يم متلاطمة أمواجه. لم يكن مهيأ لخوض كل هذه المعارك، لكنها الأقدار ساقته إلى ما لا يعرف من الدروب، وطوّحت به بين المدائن والمداشر يتنكب لقمة يسكت بها سغبه.
الرجل الذي فقد صاحبه.. – قصة: عبد القادر القادري
استفاق أحمد مضطرب المزاج، مشوش الذهن.. حاول ان يطرد من رأسه أفكارا و هواجس ليبدأ نهاره كالمعتاد، لكن تأثير الصدمة كان أقوى .. فلم تفلح محاولاته الكثيرة للعثور على الكتاب..الكتاب الازرق او الصديق الوفي كما يحلو له ان يسميه..
لقد قضى البارحة يومه باحثا عنه ، لكن اجتهاده باء بالفشل..
الكتاب عنده بمنزلة الصديق..
اشتراه عندما كان طالبا في المستوى الاعدادي..
لازمه طيلة سنوات الدراسة، وكان فخوارا به بين زملائه..
بحث عنه وسط كومة كتب قديمة قل استعمالها، وداخل مجموعة أوراق ملقاة بأحد جوانب البيت.. وفكر ان يسأل زوجته في الموضوع لكنه تراجع عن الفكرة..
لهفته على الكتاب ليس لها حد، وفكرأن يسأل صديقه بشير الذي شاركه غرفة بالحي الجامعي أيام الدراسة فأجابه الصديق قائلا« ما عادت لي صلة بالكتب مثلما كنت يا صديقي..العمل في الادارة يأخذ كل وقتي..».
وتبقى الذكريات – قصة: أسماء العسري
حنين، حنيني إليك، أين المفر منه ومنك؟ فأنا أهرب منك إليك، أهرب بعيدا، وما تهرب إلا مخيلتي وراء الذكريات، فأين المفر؟ أهرب لأجد نفسي في حضن الذكريات، ذكريات قال عنها إنها زادي وملاذي في ساعات الوحدة، لأعثر عليها تتلصص على ألمي وتتفق مع الشيطان في طرح جسدي لخبايا الشر، تقدم دموعي ونزيف قلبي قرابين ليظل سيّد الشر، وتظل هي عالقة في مخيلتي، إفرازات الهوى تشدني بخيط ناظم يفصل بينه وبين ذكرياته، يمكن أن نقول عنه فن الوخز بالإبر؛ وخز يجعلك تحس بالألم في البداية؛ ثم يتلاشى شيئا فشيئا من مخيلتك الصغيرة، لكن الوخز الحقيقي الذي يوجعنا أكثر و يظل يرافقنا، هو وجع ذكرياتنا.
هذه أول خاطرة لندى مع أفكارها، عنونتها ب: "لماذا أكتب"، وكان هذا أول تساؤل انتاب مخيلتها، و أول كلمات أثقلتها ليلة كاملة منذ أن التقت بأحمد زميل دراستها القديم، أعادت رفع القلم مرة ثانية بعد أن انتهت من مناوشاتها مع ذكرياتها، لكنها عجزت عن الكتابة، شملت جسدها رعشة رقيقة؛ رعشة الموت و الحياة، لم تجد سلواها إلا في تسليم أمرها للدموع، والمشي بخطوات مبعثرة من اليمين إلى اليسار؛ ومن اليسار إلى اليمين، تحاول شغل أفكارها عن التفكير في أحمد، ظلت ليلة كاملة ما بين جبروت الصحوة و ميلان النوم، منتظرة بكل لهفة بزوغ شمس يوم جديد.
في الصباح الباكر خرجت ندى تهرول بين الأزقة والشوارع هائمة على وجهها مثل شخص نسي اتجاهاته، أو كأنها هاربة من شبح يطاردها، أحست فجأة بالتعب والجوع يدغدغ أمعاءها الصغيرة، فقررت العودة إلى بيتها و تناول وجبة دسمة نكاية في طيفها المجهول، ومواجهة مخاوفها، واتخاذ القرار البعيد القريب؛ القرار الذي ظل مؤجلا لسنون من الزمن؛ بسبب خوفها وانفعالاتها التي تقف حجر عثرة في حياتها.
دخلت منزلها أخيرا، وبدأت بإعداد وجبة الفطور، وحملت كالعادة إبريقها النحاسي وبدأت في صنع قهوتها المعتادة، رغم وجود آلة كهربائية لصنع القهوة، لكن ندى تحب طعم القهوة في الإبريق؛ فرائحة القهوة تساعدها على تصفية ذاكرتها، وعند الانتهاء من وجبة الإفطار الإجباري- فالجوع سيد المواقف- حملت فنجانها و ذهبت إلى غرفتها و بدأت بخط أول كلماتها لأحمد منذ ودعتها رغبة الكتابة، اليوم تكتب بارتجاف يدها و كأنها أمام جلسة الغفران.
فرار – قصة: حسن يارتي
في بادئ الأمر كان الأمر عسيراً جداً. أن تمضي الليل مستيقظاً، ليس أفضل الخيارات. لكنني لم أكن سيد القرار. وكان عليّ تقبل وردية العمل المسائية.
لم تكن لدي مهام وافرة، بحيث أكسب وقتاً كافياً لأختلي بكنزي، وأطالع بعضاً من فصول كتابي، فطالما عشقت مجالسة المؤلفات والدواوين في الليالي الحالكة، أستدفئ بدفئها وأستنير بنورها.
لا أحد يزعجني. وحدها أصوات الأجهزة كانت تلاطف مسمعي وتؤنسني.
أحياناً كان زميلي أسد يأتيني بكأس القهوة، ونتجاذب أطراف الحديث، ثم يعود إلى مكتبه الذي يبعد عن مكتبي بثلاثة أَقسام.
مضت سبعة أشهر على هذا الحال الذي لم أرتح له، لكن قبِلت به إلى أن حانت ليلتي الأخيرة هناك.
كنت أستمتع بكوب قهوتي في المنزل حين هاتفني حسين مساءً. توسّلني أن أعمل مكانه تلك الليلة بسبب مرض ابنته صوفيا التي كنت أحب ملاعبتها دائماً. قبِلت طلبه لعطفي على الصغيرة، ولحظي التعيس كانت ليلة ماطرة.
هاتفت سائق سيارة الأجرة، الذي كان رقمه المحمول بحوزتي، وأقنعته بإيصالي إلى مكان عملي في أجواء عاصفة.
لدى بلوغي المقر، وجدت أسد في انتظاري عند المدخل، لكن مزاجي السيئ منعني من أن أبادله التحية بأحسن منها فدخلت مسرعاً.
مضت من وقتي ساعة في تعديل الملفات، التي عرفت كثرة الأخطاء، وبعد تعبي قصدت آلة القهوة، لأعدل مزاجي الذي تعكر بسبب غباء الموظفين في التعامل مع المعلومات، فأحسست أن مقر عملي مكتظ بالبلهاء.