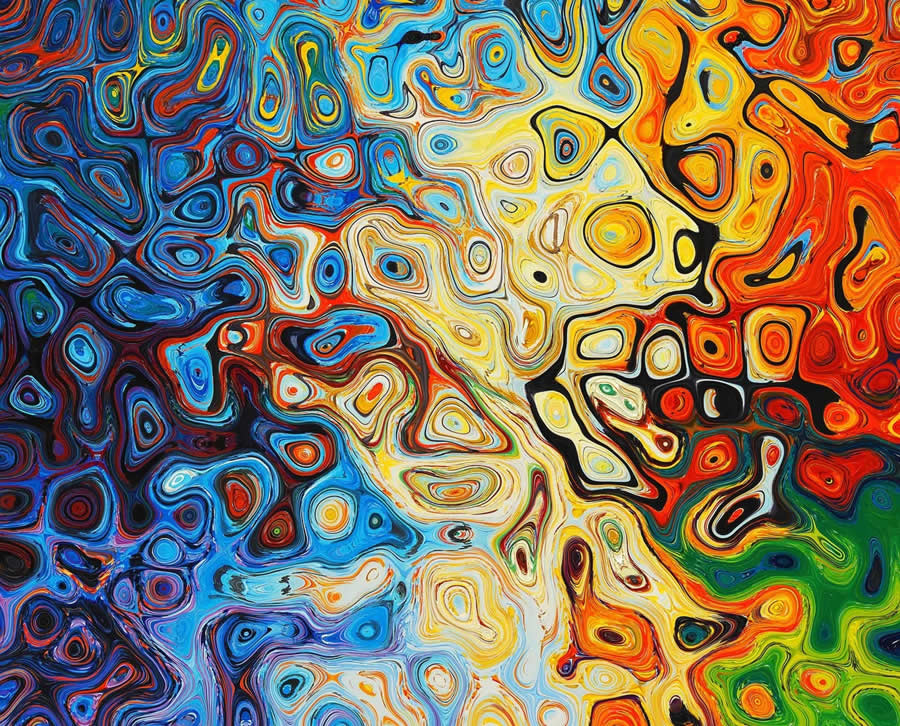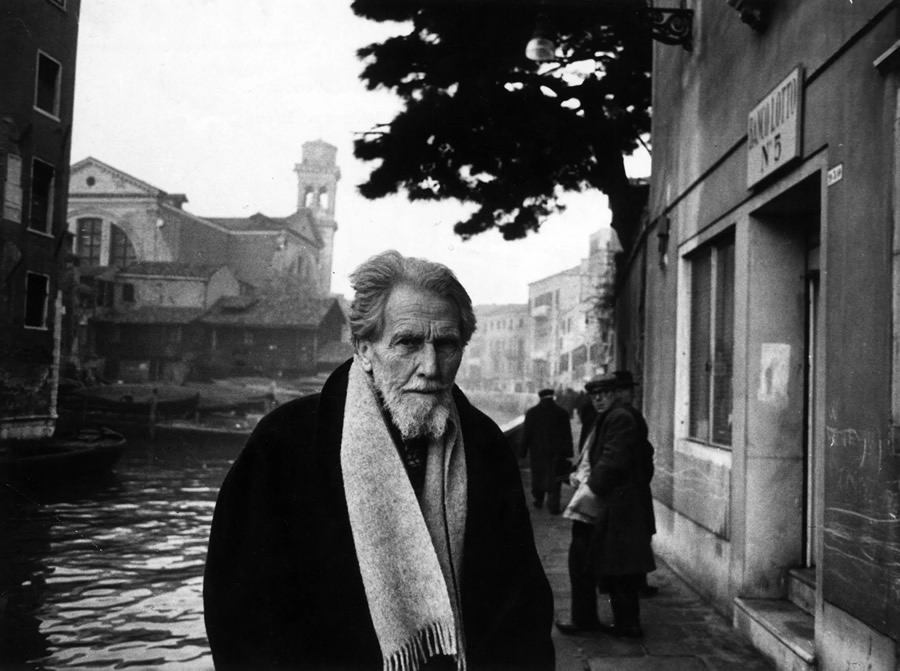".. وإنما يستبدع ذلك ممّن زجّى عمره راتعاً في مائدتهم تلك ثمّ لم يقْوَ أنْ يتنبّه."[1]
فاتحة
قُلنا في بداية هذه السّلسلة من المقالات أنّها مُخصّصة لاستعمال محمد العمري للبلاغيّين العرب القدامى في كتاب "المحاضرة والمناظرة"، الّذي ألّفه للدّفاع عن البلاغة ومناقشة كتاب "التبالغ والتبالغية" لرشيد يحياوي، وقد دفعنا اختلاط ما قاله فيه عن السّكاكي إلى مراجعة كتاب "البلاغة العربية، أصولها وامتداداتها" علّنا نعثر فيه على بعض ما يساعد على فكّ ذلك الاختلاط وإظهار مبرّرات الأحكام المرسلة. لكنّنا وجدنا فيه، عكس ما توخّيناه، إسقاطا وتعسّفا وتزويرا لا يمكن أنْ يبرّر بالاختيار القرائي غير التّوثيقي[2]: صنّف السّكاكي "مختصراً"[3] لقّبه بـ"مفتاح العلوم"، وحدّد في مقدّمته مقاصده وفسّرها، وعيّن أنواع العلم الواجب الاعتماد عليها والاستمداد منها، وبيّن الْكَيْفيّة الّتي ينبغي أن تتراتب بها تلك الأنواع وتترابط بما يجعلها نسقا نافعا لعموم المهتمّين بالأدب في زمانه، وبرّر كلّ ذلك تبريرا علميّا كافيّا لا يخفى على المنصف، واحتاط بأنْ خاطب قارئه قائلا له إنّ "الاستعمال بيدك"[4]؛ بيد أنّ العمري يَكْفُر كلَّ ذلك، ويتورّط في الإتيان بآراء غريبة وأحكام متعسّفة وتَقوّلات غاية في الفحاشة، بدا معها صاحب المفتاح متهافتا، ومختزلا، ومحكّماً للنّحو والمنطق في البلاغة!. وقد ناقشنا بعض ذلك، وظهر لنا أنّ العمري ساقه بدون تحقيق، وحشر في كلامه آراء متفاوتة ينفي بعضها بعضا ويقع جلّها بعيداً عن بنية المفتاح ومقاصده.. لهذا نعود إلى كتاب "المحاضرة والمناظرة " الّذي نخصّص له هذه السّلسة من المقالات لمناقشة "محاضرته" الّتي يجعل من طوائف مخاطَبيه فيها الطلبة والتّلاميذ[5]!
- الجرجاني والسّكاكي مؤسّسان ومختزلان:
يقول العمري: «بدأت عملية اختزال البلاغة العربية مع الجرجاني نفسه، ثم خَطتْ خطوةً واسعةً مع السكاكي، وبلغت نهايتها مع القزويني وباقي الشراح والملخصين. ولا لوم على أحد منهم، فقد استجابوا جميعا لحاجيات عصرهم وأسئلته، واستثمروا إمكانياته. بل يمكن شكر المتأخرين منهم على إيواء البلاغة في لحظات احتضارها كما آوتها الكنيسة في أوروبا بعد ذهاب شبابها اليوناني واللاتيني. سنبدأ من البداية ونسير مع عملية الاختزال خطوة خطوة إلى العصر الحاضر[6] «.
قلتُ: يكفي أن تعرف أنّ العمري يرى، مثل آخرين كثيرين، أنّ عبد القاهر الجرجاني " هو المؤسّس الحقيقي للبلاغة العربية"[7]، وتعرف أنّه يرى، وحدَه هذه المرّة، وكما هو واضحٌ في هذا المقتطف، أنّ عبد القاهر الجرجاني نفسه هو أوّل من اختزل تلك البلاغة لتتأكّد من تنكّبه عن سبل الضّبط والتّحقيق في "المحاضرة والمناظرة". ففي الرّأي الّذي لا يقيم للمعرفة – بلهَ العلم- وزنا يمكنك دائما أن تقول إنّ الجرجاني أسّس البلاغة واختزلها، وتبرّر التّنافي بالقول إنّ ذلك الاختزال إنّما هو اختزالٌ منهاجي يمكن أن يؤيّد أو يعارض، دون أن تكلِّف نفسك بأن تسأل: إذا كان هو المؤسّس، فبالقياس إلى ماذا يمكن اعتبار عمله مختزلا؟ ومادام اختزاله اختزالا منهاجيّا، فكيف يمكن أنْ يُؤيّد أو يُعارض؟ لا يجب أن نكلّف أنفسنا السّؤال لأنّ كلّ ذلك سائغ في المحادثات التي يتحكّم فيها الهوى والرّأي بعيدا عن واجب التّفكير في تحقيق القول والتّدليل عليه: يتحدّث بعض المهتمين بالبلاغة من المعاصرين عن "البلاغة العامّة"، وفي مرحلة ما قبل الجرجاني كان هناك الكثير ممّن تناولوا، من زوايا مختلفة، جوانب ومسائل أدخلها الباحثون في مرحلة ما بعد السّكاكي في التّخصص الّذي لقّبه بعضُ المتأخّرين بالبلاغة، لذا، فإنّ الجرجاني حتّى وإنْ كان هو "المؤسّس الحقيقي للبلاغة" بالنّسبة للعمري، فإنّه مع ذلك هو الّذي اختزلها- ولا تستغرب!- لأنّه لم يجعلها عامّة بجمع كل ما كان منتشرا قبله!. نعم تجمّعت عنده كلّ الرّوافد، ولكنّه قلّل من قيمة الموازنات!! طيّب، ماذا لو جعلتَ "بلاغة" الجرجاني تتوسّع لتشمل "فصاحة" ابن سنان وغير ابن سنان أكانت البلاغة ستصير عامّة تماثل ريطوريقا أرسطو التي كانت نصب عين جيرار جنيت وغيره ممّن اقتفوا أثره وتحدّثوا عن البلاغة العامة والبلاغة المختزلة من الغربيّين؟ وعلى فرض أنّها ماثلتها أو فاقتها من حيث "المساحة" أكانت تسدّ مسدّ هذا النّموذج الكلّي الّذي يطمح إليه المختصّون زمننا هذا دون أن يقدر أحد على ادّعاء أنّه بناه على الوجه الّذي ينشد؟ وهل هناك إمكانية أصلا لإنشاء ذلك النّموذج الكلّي؟ وماذا لو كان ما يتحدّث عنه العمري بهذه الطّريقة الّتي تجمع الإسقاط والتّخبّط والوثوقيّة لا يوجد إلا في وهمه؟ كلّ ذلك لا يعني شيئا لصاحب "المحاضرة والمناظرة"؛ والمنطلق عنده متهافت: البلاغة العربية كانت عامّة قبل أن تتأسّس، وقد اختزلها المؤسِّس. ما هو علم البلاغة الّذي اختزله الجرجاني؟ الجرجاني اختزل علم البلاغة الّذي لم يكن! أو كانت ظواهره ومباحثه تتبلور تدريجيّا في النّحو والتّفسير وعلم أصول الدّين وأصول الفقه والنّقد الأدبي والإعجاز!