 تغيرت دلالة القانون بشكل عميق مع المنعطف الديمقراطي الذي عرفته الفلسفة السياسية بفضل روسو. فمن اعتباره أداة لتنظيم العلاقات بين الأشخاص والسلط، أصبح القانون الوسيلة التي بواسطتها يعبر المجتمع عن إدراكه لذاته، وإرادته المستقلة، ومن هنا، لم يعد المواطن متصورا كمواطن يخضع لسلطة شرعية حيث بإمكانه الإفادة من قوانين بالمعنى الليبرالي للكلمة. ذلك أنه يتحدد، استقبالا كشخص واع يشارك في سيرورة متواصلة بواسطتها يفكر المجتمع في ذاته، ويتخذ قراره، والحال أن الأنظمة الغربية –رغم ادعاءاتها- حققت، وبشكل ناقص جدا، الإمكانيات الديمقراطية الخاصة بالقانون الحديث كما سبق أن اكتشفها روسو. يبدو أن الشكل التمثيلي للسلطة السياسية، المنحدرة من تجارب ثورية، قد اقتصر فقط على عملية ترويض القوى الديمقراطية كما سبق أن أكد على ذلك النقد الاشتراكي لـ"الدولة" البورجوازية في القرن التاسع عشر.
تغيرت دلالة القانون بشكل عميق مع المنعطف الديمقراطي الذي عرفته الفلسفة السياسية بفضل روسو. فمن اعتباره أداة لتنظيم العلاقات بين الأشخاص والسلط، أصبح القانون الوسيلة التي بواسطتها يعبر المجتمع عن إدراكه لذاته، وإرادته المستقلة، ومن هنا، لم يعد المواطن متصورا كمواطن يخضع لسلطة شرعية حيث بإمكانه الإفادة من قوانين بالمعنى الليبرالي للكلمة. ذلك أنه يتحدد، استقبالا كشخص واع يشارك في سيرورة متواصلة بواسطتها يفكر المجتمع في ذاته، ويتخذ قراره، والحال أن الأنظمة الغربية –رغم ادعاءاتها- حققت، وبشكل ناقص جدا، الإمكانيات الديمقراطية الخاصة بالقانون الحديث كما سبق أن اكتشفها روسو. يبدو أن الشكل التمثيلي للسلطة السياسية، المنحدرة من تجارب ثورية، قد اقتصر فقط على عملية ترويض القوى الديمقراطية كما سبق أن أكد على ذلك النقد الاشتراكي لـ"الدولة" البورجوازية في القرن التاسع عشر.
تعزز هذا الاتجاه مع مجيء الدولة الراعية (Etat Providence)، ذلك أن وضع آليات للحماية (= الرعاية) الاجتماعية كان جد مكلف من أجل وصاية متزايدة، وتشجيع لإعادة توجيه الأفراد نحو الحياة الخاصة، والاستهلاك الذي أدى إلى عدم الاهتمام بالدائرة العمومية. لقد أصبحت السياسة منكرة على المجتمع المدني أكثر من أي وقت مضى. ومع ذلك، هناك إشارات إلى أن هذه الوضعية بدأت تتغير. فالعداوة النامية إزاء إغواء السياسي للنخب التقنوقراطية ومحترفي السياسة، وتوسيع الممارسات الديمقراطية لتطال ميادين جديدة، والإحلال الصعب لديمقراطية محلية والدور المتكاثر لـ"حركات اجتماعية"، والتزامات المواطنين –كل هذا يشير إلى إرادة للإفلات من خيار خاطئ بين ديمقراطية "تمثيلية" تكشف –أمام أعيننا- عن حدودها، وبين ديمقراطية مباشرة أمست مستحيلة –كما سبق أن أشار إلى ذلك روسو- من خلال الشروط الاجتماعية للحداثة. هناك طريق ثالث ضمن الممكنات المحركة التي يتضمنها عصرنا، ويتعلق الأمر بـ ديمقراطية راديكالية يسودها مبدأ التنظيم الذاتي للمجتمع ذي الأنماط المتعددة.
بين الفلسفة والشعر ـ عبد الفتاح كيليطو
 هل يستطيع المرء امتلاك لغتين؟ هل بإمكانه أن يبرع فيهما معا؟ ربما لن نهتدي إلى جوانب إلا إذا أفلحنا في الإجابة عن سؤال آخر: هل يمتلك المرء لغة من اللغات؟ أتذكر أنني سمعت كلاما لم أعثر بعد على مرجعه، يصف فيه أحد القدماء علاقته بالعربية، فيقول: "هزمتها فهزمتني، ثم هزمتها فهزمتني"، مشيرا إلى أن علاقته بها متوترة، وأن الحرب سجال بينهما، مرة له ومرة عليه؛ ولكن الكلمة الأخيرة لها، لهذه الكائنة الشرسة التي تأبى الخضوع والانقياد. ينتهي القتال دائما بانتصارها، ولا يجد المرء بدا من مهادنتها ومسالمتها والاستسلام لها، وإن على مضض.
هل يستطيع المرء امتلاك لغتين؟ هل بإمكانه أن يبرع فيهما معا؟ ربما لن نهتدي إلى جوانب إلا إذا أفلحنا في الإجابة عن سؤال آخر: هل يمتلك المرء لغة من اللغات؟ أتذكر أنني سمعت كلاما لم أعثر بعد على مرجعه، يصف فيه أحد القدماء علاقته بالعربية، فيقول: "هزمتها فهزمتني، ثم هزمتها فهزمتني"، مشيرا إلى أن علاقته بها متوترة، وأن الحرب سجال بينهما، مرة له ومرة عليه؛ ولكن الكلمة الأخيرة لها، لهذه الكائنة الشرسة التي تأبى الخضوع والانقياد. ينتهي القتال دائما بانتصارها، ولا يجد المرء بدا من مهادنتها ومسالمتها والاستسلام لها، وإن على مضض.
إذا كان هذا حال المتكلم مع لغة واحدة، مع لغته، فكيف حاله مع لغتين أو أكثر؟ كيف ينتقل من هذه إلى تلك، كيف يتصرف بينهما، وكيف يتدبر أمره مع الترجمة المستمرة التي يمارسها؟ سأحاول الخوض في جانب من هذه الأسئلة استنادا إلى الجاحظ، إلى كاتب لا نعرف بالتأكيد إن كان يتقن لغة غير العربية، مع العلم أن في مصنفاته علامات تشير إلى أنه لم يكن يجهل الفارسية.
ولنبدأ بما قال في البيان والتبيين عن أبي علي الأسواري، الذي قص في أحد المساجد "ستا وثلاثين سنة، فابتدأ لهم في تفسير سورة البقرة، فما ختم القرآن حتى مات، لأنه كان حافظا للسير، ولوجوه التأويلات، فكان ربما فسر آية واحدة في عدة أسابيع". إن تفسير القرآن عملية طويلة لا يحدها إلا عمر المفسر.. بأية لغة كان أبو علي الأسواري ينجز شرحه؟ بالعربية طبعا، والظاهر أن جمهوره يتكون أساسا من العرب، ومن بعض العجم الذين تعلموا العربية. ولكن كيف كان يتم تفسير كتاب الله لأولئك الذين يجهلون اللغة التي أوحي بها؟
اللعب والكلام ـ Francis Wy brands ـ ترجمة : الحسين سحبان
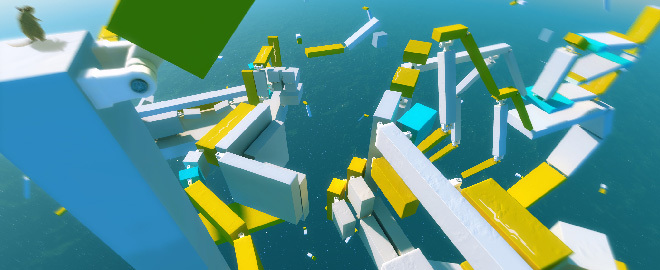 "أما كل شيء إذن إلا لعب ومبادلة أو تحويل لشيء لا يتبدل le même، فلا يلفى في أي جهة اسم، ولا مكان حتى لربح أو مكسب حميم." ريلكه، مرثية (إلى مارينا تسفيتايفا) ترجمة: Ph. Jaccottet
"أما كل شيء إذن إلا لعب ومبادلة أو تحويل لشيء لا يتبدل le même، فلا يلفى في أي جهة اسم، ولا مكان حتى لربح أو مكسب حميم." ريلكه، مرثية (إلى مارينا تسفيتايفا) ترجمة: Ph. Jaccottet
"أدعوكم للعب، للنظر بانتباه… أدعوكم للتفكير"
أ.تابيز، ممارسة الفن ("أفكار"، غاليمار، ص 144).
"ليس في اللعب "لأن"، ولا "لماذا". إن اللعب هو لعب حين يجري. فاللعب هو وحده الذي يبقى: إنه أسمى وأعمق ما يوجد.
غير أن "وحده" [ لا يعني أن اللعب جزء من كل، بل يعني أنه ] هو الكل، وأنه الواحد الأوحد".
م.هيدجر، مبدأ السبب (ترجمة A.Breau، ص 243)
يكشف اللعب عن نفسه في أوجه تتعدد بحيث يبدو من المستحيل بلوغ أي إدراك لمعناه في مستوى المفهوم. إذ ما هو المشترك، بالفعل، بين لعب [حركة ارتفاع وانخفاض] الأمواج le jeu des vagues، ولعب(1) (التلاعب) الكلمات le jeu des mots ، بين اللعب الذي يخص به الأطفال وبين اللعب [مجموع الحركات الآلية] الذي يتيح لقطع آلة أن تشتغل؟ تجاه هذا التبعثر الذي يحول دون التفكير في اللعب، بسبب حصره، في كل مرة، لمعنى اللعب في دائرة منفصلة (جمالية، لسانية، سوسيولوجية، سيكولوجية…)، يمكن، مع ذلك، إبراز تصورين كبيرين للعب:واحد لهوي ludique، وآخر كوسمولوجي Cosmologique. يقول أحد هذين التصورين إن كل شيء لعب: كل شيء يلعب من الإنسان إلى الإله. ويقول التصور الآخر إن الكائن، في مجموعه، هو، في عمقه، لعب. إن كان لا فرق بين هذين التصورين، اللذين يقولان الشيء نفسه le même، سوى في التشديد والتوكيد، فذلك لأنهما قائمان على أساس واحد غير مفكر فيه. [هذا الأساس هو الذي يكشف عنه] هيدجر في اعتراضه على الطابع الأنثروبولوجي لكل تصور لهوي للعب، وعلى الصبغة "الميتافيزيقية" لكل تصور كوسمولوجي للعب.
حوار كليمان روسي : شوبنهاور فيلسوف مثير وجذاب – ترجمة: ادريس بنشريف
 لا تكمن جاذبية شوبنهاور بالنسبة للفيلسوف الفرنسي المعاصر كليمان روسي، في نزعة التشاؤم التي وسمت فلسفته؛ وإنما في الخلاص من تراجيديا الوجود وعبثيته المصاحبة لإرادة الحياة. خلاص يجد في البعد الإستيطيقي علاجا حقيقيا لمأساة الإنسان، إنه ليس علينا أن نجد متعة في آلام الحياة وأوجاعها، وإنما ينبغي علينا أن نتمسك بفرحة الحياة رغم الجوانب المأساوية للواقع والوجود بتعبير نيتشه؛ليس من الصدف السعيدة إذن، أن تشكل العلاقة شوبنهاور نيتشه مركز الثقل في اهتمامات كليمون روسي،إنها ليست بالعلاقة الواضحة كما يدعي البعض؛ بالنسبة لنيتشه يتجه المرح دوما إلى أقصى الحدود مقارنة بالحزن عند شوبنهاور، إذ ظل تحليل الضغينة مغيبا عند هذا الأخير في الوقت الذي أخضعها نيتشه لمطرقة النقد الجينيالوجي.
لا تكمن جاذبية شوبنهاور بالنسبة للفيلسوف الفرنسي المعاصر كليمان روسي، في نزعة التشاؤم التي وسمت فلسفته؛ وإنما في الخلاص من تراجيديا الوجود وعبثيته المصاحبة لإرادة الحياة. خلاص يجد في البعد الإستيطيقي علاجا حقيقيا لمأساة الإنسان، إنه ليس علينا أن نجد متعة في آلام الحياة وأوجاعها، وإنما ينبغي علينا أن نتمسك بفرحة الحياة رغم الجوانب المأساوية للواقع والوجود بتعبير نيتشه؛ليس من الصدف السعيدة إذن، أن تشكل العلاقة شوبنهاور نيتشه مركز الثقل في اهتمامات كليمون روسي،إنها ليست بالعلاقة الواضحة كما يدعي البعض؛ بالنسبة لنيتشه يتجه المرح دوما إلى أقصى الحدود مقارنة بالحزن عند شوبنهاور، إذ ظل تحليل الضغينة مغيبا عند هذا الأخير في الوقت الذي أخضعها نيتشه لمطرقة النقد الجينيالوجي.
ليس الأهم في هذه العلاقة، حسب فيلسوفنا، نقط التقاطع؛ بل هي نقط التمايزات حيث التحرر من سلطة المربي تقتضي الاحتفاء بموته الرمزي. هكذا وتحت تأثير نيتشه سقط شوبنهاور في طي النسيان طيلة عقود فلم يعد أي داع للحديث عن تشاؤميته ،والإحتفاء بها. لكن اللقاء مع فلسفة سيوران شكل منعرجا حاسما أعيد فيه الاعتبار لشوبنهاور من خلال ثلاث مسائل أساس:
أولها غلبة قوى الرغبة والغريزة على قوى اللوغوس ،ثانيها مأساوية الوجود وعبثيته،ثالثها الأفق الذي يفتحه الـتأمل الإستيطيقي لتخليص الإنسان من المعاناة المصاحبة لإرادة الحياة؛ فكل براهيننا وتفسيراتنا العقلية حول العالم وحول أنفسنا ليست سوى نتاج إرادة عمياء تنفلت منا كطاقة عمياء و هوجاء تسري في العالم. لكن كيف يمكن أن تكون الإرادة سبب معاناتنا ، بينما الموسيقى كتعبير عن هذه الإرادة هي مصدر مرحنا ؟مفارقة أرقت كليمون روسي منذ ستينيات القرن المنصرم دون أن يجد لها جوابا شافيا ؛لذا لم يعتبر فلسفة شوبنهاور مجرد مسكن للألم؛بل هي أعمق من ذلك ،إنها فلسفة إستيطيقية تحمل من التميز والأصالة ما يبهر؛فكان لها بحق الأثر البالغ في التيارات الفنية للقرن العشرين.
هُومِيرُوسْ ـ نص : إِدْوَارْدُو غَالْيَانُو ـ ترجمة :د. لحسن الكيري
 لم يكن يوجد شيء و لا أحد. و لا حتى الأشباح كانت توجد. لم يكن هناك أكثر من مجرد صخور صماء، و نعجة أو نعجتين تبحثان عن الكلإ بين الخراب.
لم يكن يوجد شيء و لا أحد. و لا حتى الأشباح كانت توجد. لم يكن هناك أكثر من مجرد صخور صماء، و نعجة أو نعجتين تبحثان عن الكلإ بين الخراب.
لكن هذا الشاعر الأعمى عرف كيف يرى، هنالك، تلك المدينة الكبيرة التي لم تكن توجد. رآها محاطة بالأسوار الضخمة، سامقة فوق التل مشرفة على الخليج؛ و سمع ولولات و زمجرات الحرب التي دمرتها.
و أنشدها. كان ذاك إعادة تأسيس لطروادة. لقد ولدت طروادة من جديد. ولدت من كلمات هوميروس، بعد مرور أربعة قرون و نصف على إبادتها. و هكذا انتقلت حرب طروادة، التي كانت منذورة للنسيان، إلى أشهر حرب بين الحروب.
يقول المؤرخون إنها كانت حربا تجارية. بحيث أغلق الطرواديون ممر العبور نحو البحر الأسود و أنهم كانوا يجنون ربحا كبيرا من ذلك. و أباد الإغريقيون طروادة كي يفتحوا لأنفسهم ممرا نحو الشرق عبر معبر الدردنيل. لكن كانت كل الحروب التي شهدها العالم تجارية أو تقريبا كلها كذلك. لماذا يمكن أن يحق لهذه الحرب التي تكاد تكون غير حقيقية أن تخلد في الذاكرة؟
ألبير كامي، أو اللاشعور الاستعماري ـ إدوارد سعيد ـ ترجمة: محمد هشام
 ألبير كامي (Albert Camus) هو المؤلف الوحيد من الجزائر الفرنسية الذي يمكن، ببعض التبرير، أن يعتبر أن له مدى عالميا. ومثل جين أوستين (June Austen كاتب بريطاني، 1775-1817)[1]، قبل قرن من الزمان، فإنه روائي تركت مؤلفاته تفلت من يدها واقع الأشياء الإمبراطورية التي كانت تقدم ذاتها بكامل الوضوح إلى انتباهه(…).
ألبير كامي (Albert Camus) هو المؤلف الوحيد من الجزائر الفرنسية الذي يمكن، ببعض التبرير، أن يعتبر أن له مدى عالميا. ومثل جين أوستين (June Austen كاتب بريطاني، 1775-1817)[1]، قبل قرن من الزمان، فإنه روائي تركت مؤلفاته تفلت من يدها واقع الأشياء الإمبراطورية التي كانت تقدم ذاتها بكامل الوضوح إلى انتباهه(…).
يلعب كامي دورا هاما على نحو خاص في الرجات الاستعمارية المشؤومة التي صاحبت المخاض العسير لنهاية الاستعمار الفرنسي في القرن العشرين. إنها صورة إمبريالية متأخرة جدا: فلم يتخلف عن ذروة الإمبراطورية وحسب، وإنما بقي كمؤلف "عالمي" يغرز جذوره في استعمار تم نسيانه الآن (…).
إن المقارنة المدهشة بين كامي وجورج أورويل[2] هي أنهما صارا، كل واحد في ثقافته الخاصة، يمثلان صورتين نموذجيتين تنجم أهميتهما عن قوة السياق الأهلي المباشر الذي يظهران أنهما يتعاليان عليه. ولقد قيل هذا على أكمل وجه في حكم على كامي يبرز تقريبا عند نهاية عملية إزالة الزيف عن الشخص التي يمارسها كونور كريز أو بريان (Conor Cruise O'Brien) في كتاب يشبه كثيرا دراسة رايمون وليامز (Raymond Williams) عن أورويل[3]، يقول أوبريان: "من المحتمل ألا يكون أي مؤلف أوروبي من زمانه قد أثر بعمق، مثلما فعل، على المخيال والوعي الأخلاقي والسياسي لجيله وللجيل الذي تلاه. لقد كان أوروبيا بشكل كثيف لأنه كان ينتمي إلى حدود أوروبا وكان واعيا بتهديد ما. ولقد كان التهديد أيضا يرنو إليه بشغف. ولقد رفض، ولكن ليس دون صراع. ولم يعد أي كاتب آخر، حتى كونراد (Conrad) نفسه، يمثل الاهتمام والوعي الغربي إزاء العالم غير الغربي. ولعل المأساة الداخلية لآثاره هي تطور هذه العلاقة، تحت صعود الضغط والقلق".
أعداء التنوير ضدّ المبادئ الإنسانية : حوار مع مؤرخ الأفكار "زائيف ستارنهالZeev Sternhell " ـ ترجمة: محمد عادل مطيمط
 (حوار مع مؤرخ الأفكار "زائيف ستارنهالZeev Sternhell ")
(حوار مع مؤرخ الأفكار "زائيف ستارنهالZeev Sternhell ")
مجلة "هومانيسمHumanisme "، 297، اكتوبر، 2012
المجلّة:
السيد المحترم "زائيف ستارنهال"، يشرّفنا التحاور معكم حول مسألة معاداة التنوير، أي حول موضوع كنتم قد سخّرتم من أجله جهودا كبيرة. ولننطلق في ذلك من طرح سؤال بسيط: ماذا تعنون بتياّر معاداة التنوير؟ ثم إننا نريد أن نعرف بصفة خاصة ما إذا كان الأمر يتعلق بحركةMouvement أم بتيّارCourant، وهل يتعلق الأمر بمجموع منسجم أم بأطروحات متنوعة؟ ثم من هم هؤلاء المفكرون الذين تستندون إليهم؟
"زائيف ستارنهال":
في البداية أشكركم على هذه الاستضافة من أجل التعبير عن أفكاري في مجلة تبدو أهدافها واضحة تماما من خلال عنوانها [Humanisme]، الأمر الذي يمثل في حد ذاته برنامجا قائما. يُمثل أعداء التنوير تيّارا، وقد استخدمت كلمة تقليدTradition أيضا بهدف التأكيد على جانب الاستمرارية في الزمن. علينا بهذا المعنى أن نؤكد على حقيقة أن أعداء التنوير تماما مثلما هم في الجانب الآخر أنصار التنوير لا يشكلون دائما مدوّنة أفكار منسجمة، بل يتعلق الأمر بتقليدين فكريين يرميان إلى تحقيق أهداف عملية مباشرة[1]. فالتنوع [الداخلي] والتناقضات الداخلية يمثلان إحدى الخصائص المميّزة لهذين التقليدين. وبالتالي فإنّ إنكار هذا التنوع سيمثّل خطأ [منهجيا] فادحا. فرغم هذا اللاّ-تجانس Hétérogénéité ، يوجد قاسم مشترك بين كل صور وتفريعات معاداة التنوير وكذلك بين كل صور وتفريعات التنوير. ذلك هو السبب الذي يفسر أنه رغم كل ما يفصل "فولتير"Voltaire عن "رسّو"Rousseau و"رسّو" عن "كوندورسيه"Condorcet ، أو "منتسكيو"Montesquieu عن "ديدرو"Diderot والموسوعيين، فإن مفكري الأنوار الفرنسية، ومعهم حليفهم الرئيسي "كانط"E. Kant ، يتّحدون فيما بينهم عبر جملة من المبادئ تشكل لبّ الثورة الفكرية الكبيرة للقرن الثامن عشر. ودون أن نخشى طمس الحقيقة المتشعّبة لتلك الفترة الممتدة من بداية القرن الثامن عشر إلى أيّامنا هذه، فإنه من المشروع الإقرار إنه يوجد انسجام ومنطق داخلي في تقليد الأنوار وإن الانسجام نفسه يؤسس نزعة معاداة التنوير. سنتكلم عن المفكرين من معادي التنوير بعد حين، ولكننا نريد الإلحاح قبل ذلك على ضرورة عدم الخلط بين الانسجامCohérence وأحادية البعدUnidimensionnalité .
الصورة الأدبية ـ غاستون باشلار ـ ترجمة : سعيد بوخليط
 عذبة هي الأنغام التي نصغي إليها،غير أن التي لا نسمعها تفوقها عذوبة :أيضا، نصب مصائد للعصافير،أنشد دائما، ليس للأذن المرهفة الحس، لكن الأكثر إغواء،أن ترنِّم للفكر تراتيل صامتة.
عذبة هي الأنغام التي نصغي إليها،غير أن التي لا نسمعها تفوقها عذوبة :أيضا، نصب مصائد للعصافير،أنشد دائما، ليس للأذن المرهفة الحس، لكن الأكثر إغواء،أن ترنِّم للفكر تراتيل صامتة.
(Keats ,Ode a l urne grecque.trad ;E. de Clermont-Tonnerre)
هناك موسيقيون يؤلفون على الصفحة البيضاء،في ظل السكون والصمت. الأعين الكبيرة مفتوحة، تخلق بنظرة ممتدة في الفراغ، نوعا من الصمت المرئي، نظرة صامتة تمسح العالم،لكي تعمل على إسكات أصواته، إنهم يكتبون الموسيقى. شفاههم لا تتحرك. إيقاع الدم ذاته قد جف طبله، الحياة تترقب، فالإيقاع آت. يصغون إذن إلى ما يبدعونه عبر الفعل الذي يبدع.لاينتمون أبدا إلى عالم الأصداء أو الرنين، يسمعون النقط السوداء،ثم العلامات الموسيقية،والنوتات، تسقط، ترتجف، تنزلق، تقفز على صفحة الموسيقى. بالنسبة لهم، السولفيج قيثارة مجردة، رنان قبل ذلك. يتمتعون هنا،على الصفحة البيضاء،بتعدد الأصوات الواعي. في الإصغاء الواقعي، يمكن أن تضيع أصوات، تخفت،وتختنق،قد يحدث الانصهار بكيفية سيئة.لكن مبدع الموسيقى المكتوبة، له عشرة آذان ويد واحدة. يد مطبقة على قلم، لضم عالم الإيقاع ، عشرة آذان، وانتباهات، ومواقيت، قصد مطِّ و تنظيم فيض السمفونيات.












