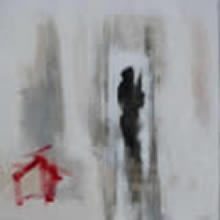 لعل التساؤل الأبرز الذي يدور بأذهان العديد هو لماذا أصبحت الميادين الرياضية مسرحا لأعمال العنف؟و هل ولى زمن شعارات الرياضة أخلاق أو لا تكون و الرياضة تحابب و تقارب؟ فهذه التساؤلات و غيرها مشروعة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الدور الذي تلعبه الرياضة اجتماعيا. لكن التساؤل الأبرز الذي يمكن طرحه هو: هل يكون اللجوء إلى العنف أمرًا مقصودًا من اللاعب أو المشجع؟ أم أنه نتيجة وضعيات صعبة وجد الفاعل نفسه محشورًا فيها؟
لعل التساؤل الأبرز الذي يدور بأذهان العديد هو لماذا أصبحت الميادين الرياضية مسرحا لأعمال العنف؟و هل ولى زمن شعارات الرياضة أخلاق أو لا تكون و الرياضة تحابب و تقارب؟ فهذه التساؤلات و غيرها مشروعة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الدور الذي تلعبه الرياضة اجتماعيا. لكن التساؤل الأبرز الذي يمكن طرحه هو: هل يكون اللجوء إلى العنف أمرًا مقصودًا من اللاعب أو المشجع؟ أم أنه نتيجة وضعيات صعبة وجد الفاعل نفسه محشورًا فيها؟لقد أصبحت الرياضة و خاصة كرة القدم تعني الكثير لدى العديد من المشجعين,فهي ذلك الوهم الجميل الذي ينتظره طوال الأسبوع,و هي الشيء المتجدد الذي يعرفه في خضم ما يعيشه من ضغوطات الحياة اليومية: العمل,العائلة,الدراسة...لتصبح الرياضة متنفسًا لكل ذلك. و إذا كان البعض يأخذ الرياضة على أنها وسيلة من وسائل الترفيه,فإنها تصل إلى حد الإدمان لدى الكثيرين أو لنقل أنها تحولت إلى أفيون الشعوب الجديد. عندها لا تصبح مباراة في كرة القدم تدور يوم الأحد أو أي يوم آخر بل أنها تتواصل لتصبح جزءًا من المعيش اليومي,فترى المحب يتابع التمارين خلال أيام الأسبوع و يلاحق الأخبار المتعلقة بفريقه المفضل,فيصبح متعايشا معه في البيت أو في العمل أو في مكان الدراسة.و ما نريد توضيحه هنا هو أن الفريق الذي نشجع يتحول إلى جزء منا و المساس به يعني المساس بشيء له من القدسية الشيء الكثير, حتى أن التحضير للذهاب إلى الملعب يكون عبارة طقوس واجبة استعدادًا لهذا الحدث.فالعاطفة هي التي تسير أفعال المشجعين تمامًا "كالصفعة التي توجهها الأم لابنها لأنه كان لا يحتمل,أو اللكمة الصادرة من لاعب فقد السيطرة على أعصابه أثناء مباراة كرة قدم. و في جميع هذه الحالات الفعل يعرف ليس بالرجوع إلى الهدف منه أو لنظام قيم بل بالعودة إلى ردة الفعل العاطفية للفاعل المحشور في وضعيات معينة."
و سنحاول هنا تحديد هذه الوضعيات التي تؤدي غالبًا إلى الانفجار. فمن المعروف أن الجمهور الرياضي أصبح فاعلا رئيسيا في النشاط الرياضي بصفته الاقتصادية كمستهلك,لذلك ترى النوادي تسعى بشتى الوسائل إلى استمالته و حثه على حضور المباريات حتى و إن كانت المخادعة وسيلة لذلك كإيهامه بالقدرة على حصد الألقاب الواحد تلو الآخر,و القول بأن النادي ملك للجمهور و مصلحته من مصلحتهم أي أنه جزءا منهم. وإذا أضفنا إلى ذلك بعض الخطابات الصحفية و التي تعتمد المبالغة كوصف مقابلة بأنها ثأرية أو مباراة الأمل الأخير و غير ذلك من الأوصاف و التي تجعل المشجع يأخذ المسألة على أنها مصيرية أو لنقل قضيته الشخصية,فتراه واقفا في الصفوف بحثا عن التذاكر وتحضير مستلزمات الاحتفال ليأتي اليوم الموعود و تجد الجماهير نفسها أمام منغصات ترى أنها تحول دونهم و دون وهمهم المنعش و الذي قدموا من أجله.



 يرمي هذا الفصل إلى القيام بمسح للمساهمات العلمية التي توفرت بصدد الطوائف الدينية، ويحاول في الوقت نفسه، أن يقرأ، نقديا، مختلف محاولات علماء الاجتماع في السنوات الأخيرة لفهم هذه الظاهرة، وتشمل هذه القراءة مستويين: المستوى النظري والمنهجي، والمستوى الميداني. كل ذلك في أفق توظيف هذا التراث لمقاربة موضوع هذه الدراسة .
يرمي هذا الفصل إلى القيام بمسح للمساهمات العلمية التي توفرت بصدد الطوائف الدينية، ويحاول في الوقت نفسه، أن يقرأ، نقديا، مختلف محاولات علماء الاجتماع في السنوات الأخيرة لفهم هذه الظاهرة، وتشمل هذه القراءة مستويين: المستوى النظري والمنهجي، والمستوى الميداني. كل ذلك في أفق توظيف هذا التراث لمقاربة موضوع هذه الدراسة . من منا لا يريد أن يكون سعيدا؟ و لكن ماسبل تحقيق ذلك؟يبدو أن كل البشر تنتابهم رغبة في أن يكونوا سعداء ولكن المشكل أنهم عاجزون أن يحددوا بيقين تام ما يجعلهم سعداء بحق و يترتب عن هذا أن مشكلة تحديد الفعل الذي يجلب السعادة هي مشكلة لا حل لها فما هي أسباب ذلك؟
من منا لا يريد أن يكون سعيدا؟ و لكن ماسبل تحقيق ذلك؟يبدو أن كل البشر تنتابهم رغبة في أن يكونوا سعداء ولكن المشكل أنهم عاجزون أن يحددوا بيقين تام ما يجعلهم سعداء بحق و يترتب عن هذا أن مشكلة تحديد الفعل الذي يجلب السعادة هي مشكلة لا حل لها فما هي أسباب ذلك؟ 1-عناصر أولية تمهيدية
1-عناصر أولية تمهيدية  تقديم عام: التبرّع بالأعضاء من رهانات العلم إلى رهانات الثقافة
تقديم عام: التبرّع بالأعضاء من رهانات العلم إلى رهانات الثقافة  نحن نعيش الموت البطيء لكوكب الأرض. إنّها تموت استخراجا وحرقا وتلوّثا وتسمّما وهي اليوم تصفّي حساباتها بعد أن امتدّت يد البشر إلى عمق أعماقها تخريبا وإهدارا.
نحن نعيش الموت البطيء لكوكب الأرض. إنّها تموت استخراجا وحرقا وتلوّثا وتسمّما وهي اليوم تصفّي حساباتها بعد أن امتدّت يد البشر إلى عمق أعماقها تخريبا وإهدارا. تتجلّى أمام عالم اجتماع الأديان اليوم تمظهرات شتّى للدّين، متمثّلة في حركات دينيّة جديدة، وأصناف مختلفة من التشدّد الدّيني، ونماذج متنوعّة من التوليفية والمسكونية، وأيضا علاقات متوتّرة بين الأديان، مع ارتفاع المناداة بهويات مميّزة عرقية وسياسية في عديد البلدان، وكذلك أنماط من التديّن العلماني، وتمازج بين الدّين وادعاءات الإشفاء، مع تطوّرات نحو أشكال من الاعتقادات الليّنة والنفعية (الدّين الجاهز)، تشهد كلّها بشكل أو بآخر على ديمومة الأهمية الاجتماعية للدّيني حتى داخل المجتمعات العَلمانية الذّائعة الصّيت.
تتجلّى أمام عالم اجتماع الأديان اليوم تمظهرات شتّى للدّين، متمثّلة في حركات دينيّة جديدة، وأصناف مختلفة من التشدّد الدّيني، ونماذج متنوعّة من التوليفية والمسكونية، وأيضا علاقات متوتّرة بين الأديان، مع ارتفاع المناداة بهويات مميّزة عرقية وسياسية في عديد البلدان، وكذلك أنماط من التديّن العلماني، وتمازج بين الدّين وادعاءات الإشفاء، مع تطوّرات نحو أشكال من الاعتقادات الليّنة والنفعية (الدّين الجاهز)، تشهد كلّها بشكل أو بآخر على ديمومة الأهمية الاجتماعية للدّيني حتى داخل المجتمعات العَلمانية الذّائعة الصّيت. في الحقيقة ينظر ماكس فيبر (عالم الاجتماع الشهير) للاخلاق الإسلامية في الفترة التي سبقت نشأة الدول الوراثية الرئيسية. أي أن فيبر كان يعتبر القرن السابع هو الفترة الحاسمة لتطور الدوافع الإسلامية. وهو في ذلك يرى أن الإسلام قبل الهجرة إلى المدينة كان مفهوماً توحيدياً نقياً يمكن أن يكون قد أنتج زهداً دنيوياً ولكن الإسلام كان قد اختلف عن هذه "الأخلاق التحولية" إذا ما استخدمنا عبارة ايزنشدات Eisenstadt بفعل قوتين إجتماعيتين. الاولى: المحاربين البدو الذين كانوا كما يدعي فيبر وهم من حملوا إجتماعياً وعلى نحو أساسي الإيمان الإسلامي والذين حولوا الإسلام الى دين شهواني يقوم على التكيف والامتثال Accommodation and Conformity والثانية الطرق الصوفية التي رفضت ملاذ العالم الإسلامي وخلقت عالما عاطفياً أخروياً للعامة. وكانت النتيجة أن الإسلام إحتوى بداخله على أخلاق للمتعة المحسوسة وأخلاق تقوم على رفض العالم ولم يستطع كلا من المقاتلين أو الصوفية أن ينتجوا مجموعة من الدوافع التي تناسب احتياجات الرأسمالية العقلانية، وقد يكون من الضروري نقد كلا من هذين التفسيرين للإسلام.
في الحقيقة ينظر ماكس فيبر (عالم الاجتماع الشهير) للاخلاق الإسلامية في الفترة التي سبقت نشأة الدول الوراثية الرئيسية. أي أن فيبر كان يعتبر القرن السابع هو الفترة الحاسمة لتطور الدوافع الإسلامية. وهو في ذلك يرى أن الإسلام قبل الهجرة إلى المدينة كان مفهوماً توحيدياً نقياً يمكن أن يكون قد أنتج زهداً دنيوياً ولكن الإسلام كان قد اختلف عن هذه "الأخلاق التحولية" إذا ما استخدمنا عبارة ايزنشدات Eisenstadt بفعل قوتين إجتماعيتين. الاولى: المحاربين البدو الذين كانوا كما يدعي فيبر وهم من حملوا إجتماعياً وعلى نحو أساسي الإيمان الإسلامي والذين حولوا الإسلام الى دين شهواني يقوم على التكيف والامتثال Accommodation and Conformity والثانية الطرق الصوفية التي رفضت ملاذ العالم الإسلامي وخلقت عالما عاطفياً أخروياً للعامة. وكانت النتيجة أن الإسلام إحتوى بداخله على أخلاق للمتعة المحسوسة وأخلاق تقوم على رفض العالم ولم يستطع كلا من المقاتلين أو الصوفية أن ينتجوا مجموعة من الدوافع التي تناسب احتياجات الرأسمالية العقلانية، وقد يكون من الضروري نقد كلا من هذين التفسيرين للإسلام.








